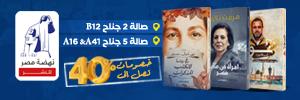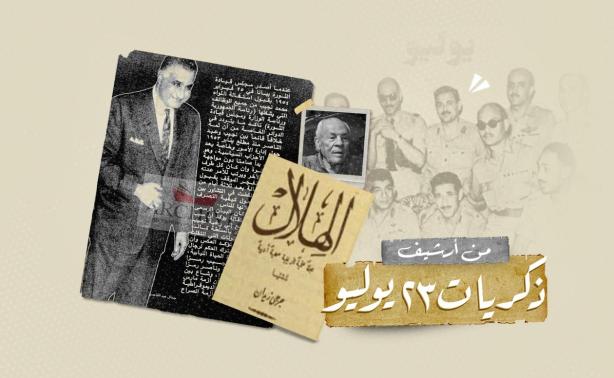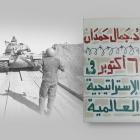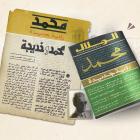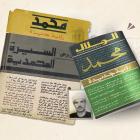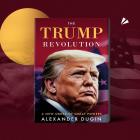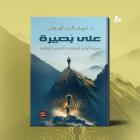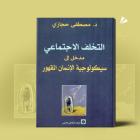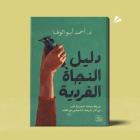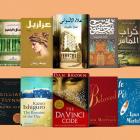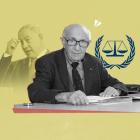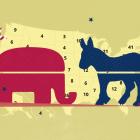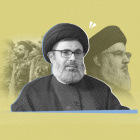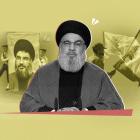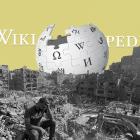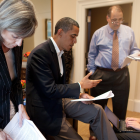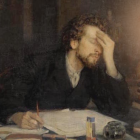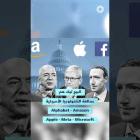والحاصل أنه في اليوم التالي لتنازل الملك فاروق عن العرش ومغادرته البلاد (٢٦ يوليو) قدّم عبد الناصر استقالته من رئاسة اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار على أساس أن التنظيم انتهى دوره بالاستيلاء على السلطة، لكن أُعيد انتخابه رئيسًا، وعُرفت اللجنة منذ ذلك الحين بمجلس قيادة الثورة.
فلما انضم محمد نجيب إلى المجلس يوم ٢٥ أغسطس تنازل عبد الناصر عن رئاسته باعتباره القائد الذي أُعلنت الثورة باسمه للجماهير، وعندما أصبح رئيسًا للوزارة (٧ سبتمبر) احتفظ لنفسه بوزارة الحربية والقيادة العامة للقوات المسلحة فضلًا عن رئاسة مجلس قيادة الثورة. ورغم هذا كان يشعر بأنه لا يسيطر على الموقف، وأن مقاليد الأمور في النهاية في يد عبد الناصر الذي يحرك مجلس القيادة. ومن ثم طلب أن يكون له حق الاعتراض على أي قرار يجمع عليه المجلس، فلم يتمكن لأن لائحة المجلس تقضي بأخذ القرار بالأغلبية.
أي إنه كان يطلب سلطة فردية مطلقة تتجاوز المجلس الذي لم ينضم إليه إلا متأخرًا. والخلاص من هذا المأزق أوحى له المقربون، وقد أصبح رئيسًا للجمهورية (٢٨ يونيو ١٩٥٣)، أن يتصل بالإخوان المسلمين للتخلص من ناصر، وكان وسيطه في هذا الاتصال قائد حرسه الخاص اليوزباشي محمد رياض الذي قابل حسن العشماوي ومنير الدلة عدة مرات في ديسمبر ١٩٥٣.
والحال كذلك لابد أن يشعر الإخوان بأهميتهم؛ فعبد الناصر حريص على خطب ودهم، والإنجليز يتصلون بهم، وها هو محمد نجيب يتصل بهم أيضًا. ومن ثم لخص الإخوان طلباتهم للوسيط (محمد رياض) وتتمثل في تشكيل وزارة يرضى عنها الإخوان، وعدم عودة الأحزاب السياسية. لكن نجيب لم يكن يملك القوة التي تمكنه من تنفيذ هذه الشروط حتى ولو كانت على هواه.
واستمر الصراع قائمًا وانقضى عام ١٩٥٣. وفي ١٢ يناير ١٩٥٤ احتفل طلاب جامعتي القاهرة والإسكندرية بذكرى شهداء الحركة الفدائية في مدن قناة السويس، فانتهز الإخوان الفرصة وأحضروا معهم زعيم حركة فدائيان إسلام الإيرانية (نواب صفوي) وسيطروا على الميكروفون واشتَبكوا مع الطلاب بالكَرابيج والعصي، فتقرر حل الجماعة بعد ذلك بيومين (١٤ يناير). فلجأ الإخوان إلى محمد نجيب لإلغاء القرار فلم يستطع شيئًا، بل لقد اضطر للتوقيع على قرار الحل باعتباره رئيس الجمهورية.
وبادر جمال عبد الناصر في خطوة محسوبة بزيارة قبر حسن البنا ومعه صلاح سالم والشيخ الباقوري بمناسبة الذكرى الخامسة لاستشهاد البنا (١٢ فبراير ١٩٥٤).
الصراع يتنامى
بعد حل جماعة الإخوان المسلمين تدهورت العلاقة بين نجيب وناصر بشكل حاد، وأراد نجيب أن يستخدم سلطاته الرئاسية لحسم الصراع فلم ينجح نظرًا لتكتل الغالبية العظمى من مجلس قيادة الثورة وراء ناصر، ربما لأن الجميع يعلمون أن ناصر هو قائد الثورة وليس محمد نجيب.
وأخذ نجيب يقلل من حضوره بالمكتب ومن لقاءاته المباشرة مع ناصر ويعتكف بمنزله أيامًا متتالية. وفكر عبد الناصر – كما يقول أنتوني ناتنج – في أن يقدّم المجلس استقالة جماعية بهدف إحراج محمد نجيب، لكن اقتراحه لم يلق قبولًا لأن المجلس لا يتمتع بالشعبية التي تمكنه من القيام بمغامرة من هذا النوع.
والحاصل أن نجيب هو الذي قدّم استقالته في ٢٢ فبراير ربما ليحرج المجلس، لكن الاستقالة قُبلت في ٢٥ فبراير وتولى ناصر رئاسة الوزارة وظل منصب رئاسة الجمهورية شاغرًا. وتجمع مختلف الروايات على أن خالد محيي الدين اعترض على قبول الاستقالة؛ لأنه كان يرى في تمسك نجيب بعودة الحياة الحزبية فرصة لليسار المنتمي، وقد اعترض معه جمال سالم – في رواية ناتنج – وعبد اللطيف البغدادي – في رواية أحمد حمروش.
على كل حال فبين إعلان قبول الاستقالة (٢٥ فبراير) وإعلان عودة نجيب في مساء ٢٧ فبراير كان الصراع على أشده بين فصائل الثوار، وتفانى كل منهما في اصطناع أساليب المواجهة والمناورة، وعاش الجميع بأعصاب مشدودة طوال ثلاثة أيام ليل نهار.
جاء أقوى رد فعل على استقالة نجيب من سلاح الفرسان حيث خالد محيي الدين القريب من نجيب. ورغم أن اليوم التالي للاستقالة كان يوم جمعة (٢٦ فبراير) إلا أن اجتماعًا تم في سلاح الفرسان بناءً على دعوة لا تفصح المراجع عن صاحبها، ولم يحضر الاجتماع خالد محيي الدين وحضره حسين الشافعي، مطالبًا الضباط بعودة نجيب وإقرار الديموقراطية وتحديد موعد عودة الجيش للثكنات، وهي نفس مطالب نجيب – خالد.
ثم حضر عبد الناصر جزءًا من المناقشات التي طالت التصرفات الشخصية لبعض الضباط، فطلب من المجتمعين الانتظار حتى يعرض الأمر على مجلس قيادة الثورة.
وفي مبنى القيادة حضر خالد محيي الدين بعد خروجه من حفلة سوارية بالسينما، وهذا وحده يفسر موقفه من البداية حيث لم يحضر الاجتماع وذهب إلى السينما في المساء حتى لا تتجه إليه الشبهات.
واقترح ناصر، الذي أدرك مرامي محور نجيب – خالد، أن يتولى خالد محيي الدين رئاسة الوزارة وأن يعمل بسرعة على عودة الحياة الدستورية، لكن خالد اعترض ليس على المبدأ وإنما لأنه بهذا سيكون وحيدًا في الساحة، فأقنعه المجلس بأن عبد الحكيم عامر سوف يكون معه لبعض الوقت فوافق خالد، وحذره كمال الدين حسين من العمل على تحويل البلد إلى شيوعية.
وعلى هذا عاد جمال مصطحبًا خالد إلى سلاح الفرسان وكانت الساعة قد بلغت الثالثة صباحًا من فجر يوم السبت ٢٧ فبراير، وأعلن لهم أن الموافقة تمت على حل مجلس القيادة، وعلى عودة نجيب رئيسًا للجمهورية، وعلى تكليف خالد بتشكيل حكومة انتقالية لمدة ستة أشهر تُجرى خلالها انتخابات لجمعية تأسيسية لوضع دستور قائم، وعودة أعضاء مجلس قيادة الثورة إلى الثكنات. وهنا ضجت القاعة بالتصفيق وتوجه خالد مغتبطًا إلى نجيب.
ولكن لما عاد خالد إلى مبنى القيادة بعد إبلاغ نجيب وجد أن معالم الصورة تتغير؛ فقد لعب الآخرون دورهم. فنجد أن ضباط الصف الثاني المحيطين بمجلس القيادة يرفضون الاستجابة لقرارات العودة إلى الثكنات، وحاولوا ضرب خالد محيي الدين، وحالوا دون تسليم بيان القرارات الجديدة إلى مندوب الإذاعة الذي كان قد حضر الساعة السابعة والنصف صباحًا. كما رفض ضباط المدفعية القرارات، وحركوا المدفعية المضادة للدبابات وحاصروا سلاح الفرسان، وأخرج سلاح الطيران – بتوجيه علي صبري ووجيه أباظة – طائرات حلّقت فوق سلاح الفرسان.
وطالب آخرون باعتقال خالد ومحاكمته، وقام كمال رفعت باعتقال محمد نجيب ووضعه في ميس المدفعية بألماظة، فغضب عبد الحكيم عامر وأعاده إلى منزله، وتم اعتقال ضباط الفرسان أنصار نجيب وتقررت محاكمتهم.
وهكذا أصبح الموقف ينذر بمعارك طاحنة بين الفصائل العسكرية؛ الفرسان مع نجيب فيما عدا حسين الشافعي، والمدفعية والمشاة والطيران مع ناصر. وفي الساعة الثالثة بعد ظهر السبت (٢٧ فبراير) كان الإرهاق قد استبدّ بالجميع، فصدر قرار برفع الجلسة للراحة أربع ساعات وانصرف الجميع إلى منازلهم. وبقي عبد الناصر مفوضًا بالتصرف إذا ساءت الأمور لحين عودتهم.
وفي تلك الأثناء انطلقت مظاهرات في الشوارع تهتف: "لا ثورة بلا نجيب"، "إلى السجن يا جمال"، "إلى السجن يا صلاح". وشهد صلاح سالم المتظاهرين أثناء عودته إلى مبنى القيادة قبل انتهاء وقت الراحة. وأخيرًا تصرف عبد الناصر بسرعة بمقتضى التفويض وقرر عودة نجيب لامتصاص الغضب ولإفشال مخطط تصفية الثورة والإطاحة برجالها، ووجّه أعضاء المجلس – وهم في منازلهم – بإذاعة نبأ عودة نجيب في الساعة السادسة.
ولم تكن عودة نجيب نهاية التوتر، بل كانت بداية جولة أخرى من الصراع والضرب تحت الحزام بين الطرفين. ففي اليوم التالي تدفقت المظاهرات إلى قصر عابدين من جامعة القاهرة لتردد هتافات عدائية ضد الثورة تزعمها الإخوان المسلمون، واصطدمت بالبوليس. يخرج نجيب إلى الشرفة واستدعى عبد القادر عودة من زعماء الإخوان إلى الشرفة بجواره لتهدئة المتظاهرين.
وفي أول مارس ذهب نجيب إلى السودان للمشاركة في افتتاح البرلمان السوداني، فأسرع ناصر باعتباره رئيسًا للوزارة باعتقال الذين اشتركوا في مظاهرات عابدين (بلغ عددهم ١١٨ أغلبهم من الإخوان يليهم جماعة أحمد حسين الحزب الاشتراكي)، ثم الوفد والشيوعيين.
وعندما عاد نجيب من السودان غضب الضباط من قيام ناصر بحملة الاعتقالات، وطلب أن يتولى رئاسة الوزارة مرة أخرى، فاضطر ناصر للموافقة وعاد نائبًا لرئيس الوزراء.
وتسارعت الحوادث وأخذ نجيب يطالب بتطبيق الشروط التي قُبلت على أساسها (وهي مطالب سلاح الفرسان) كما سبقت الإشارة.
وهكذا وفي يوم ٥ مارس صدرت القرارات الشهيرة: انتخاب لجنة لوضع الدستور وبموجبه يعاد تشكيل الأحزاب، ويكون لمجلس قيادة الثورة سلطة سيادية، ووافق نجيب على هذه القرارات بعد مقابلة خالد محيي الدين لمدة ثلاث دقائق.
وبعد إعلان القرارات انفتح باب الهجوم على الضباط الأحرار، وخاصة بعد إلغاء الرقابة على الصحف في ٦ مارس، مرددة كلام نجيب وكأنه قد خطب في نادي الضباط في ٤ مارس مطالبًا العسكريين بترك السياسة للمدنيين. وطالب الوفد بعودة الحياة النيابية، وعلي ماهر يصرح بأنه ينبغي أن تنضم مصر للمغرب، ومحمد صلاح الدين الذي كان قد قبل أن يكون سكرتيرًا عامًا لهيئة التحرير يتصل بإبراهيم الطحاوي (هيئة التحرير)، ويقترح عليه انضمام رجال الثورة إلى الوفد وأن يكون ناصر سكرتيرًا عامًا للوفد.
ويوسف صديق – وكان قد هرب من تحديد إقامته ببني سويف – تنشر له جريدة المصري رسالة يقترح فيها تشكيل وزارة ائتلافية من الوفد، والإخوان، والاشتراكيين، والشيوعيين برئاسة وحيد رأفت. والهضيبي يقيم دعوى أمام مجلس الدولة على وزارة الداخلية لإلغاء قرار حل الجماعة.
وتصرف عبد الناصر بسرعة، فكان وراء انفجار أربع قنابل في أنحاء متفرقة من القاهرة (١٩ مارس) – وفق رواية البغدادي – حتى يضطرب الموقف من جديد ويشعر الناس بعدم الأمان مع تنفيذ قرارات مارس.
وهذه الظروف التي اجتمع فيها مجلس قيادة الثورة يوم ٢٥ مارس، وتقرر فيه:
-
حل مجلس قيادة الثورة بعد فترة انتقال أربعة أشهر (أي يوم ٢٤ يوليه ١٩٥٤).
-
عودة الأحزاب السياسية.
-
ألا يشكل الضباط حزبًا سياسيًا.
-
أن تنتخب جمعية تأسيسية يكون لها سلطة المجلس النيابي تقوم بانتخاب رئيس الجمهورية.
وكان البغدادي قد اقترح في اجتماع ٢٥ مارس إلغاء قرارات ٥ مارس، لكن خالد محيي الدين تمسك بها واقترح – من باب مراوغة ناصر – تشكيلًا جديدًا لنظام ديمقراطي يحرم بمقتضاه من حق الترشيح للجمعية التأسيسية النواب الذين أيدوا من قبل القوانين المقيدة للحريات، والذين رفضوا دفع ضريبة الأطيان، ورؤساء الأحزاب، وكذا الخاضعين للإصلاح الزراعي. لكن عبد الناصر لم ينخدع باقتراح خالد وأدار المناقشة حول أحد اختيارين: إما إلغاء قرارات ٥ مارس، وإما رفع كافة القيود عن عودة الأحزاب والإفراج عن كل المعتقلين. وبعد مناقشات دامت خمس ساعات صدرت القرارات.
كان أول المفرج عنهم حسن الهضيبي المرشد العام للإخوان، الذي زار عبد الناصر في نفس اليوم (٢٥ مارس) حيث أبدى انزعاجه من قرارات ٢٥ مارس بعودة الأحزاب. فيصدر بيانًا في ٢٧ مارس يعلن أن الجماعة ستطالب بتأليف حزب سياسي، ولكن فيما يتعلق بإدارة الأحزاب فإن أملنا ألا يعود الفساد أدراجه مرة أخرى فإننا لن نسكت على هذا.
ويتحرك عبد الناصر بسرعة، فيقوم بإبعاد الضباط الذين أظهروا تعاطفًا مع الأحزاب، ويفرج عن الضباط الأحرار الذين سبق اعتقالهم، ويزور حسن الهضيبي ويتفق معه على عودة الجماعة لنشاطها. ثم يحدث إضراب عمال النقل في ٢٧ مارس تأييدًا للثورة.
وكان هذا الإضراب أصلًا من تنظيم محمد نجيب – خالد بمساعدة يوسف صديق الذي استدعى قريبه صاوي أحمد صاوي رئيس اتحاد عمال النقل المشترك، ومحمدي عبد القادر سكرتير الاتحاد، حيث تمّ الاتفاق في منزل نجيب مقابل مبلغ من المال على أن يقود صاوي الإضراب والاعتصام لإجبار الضباط على العودة إلى الثكنات دون انتظار ليوم ٢٤ يوليه ١٩٥٤ المحدد طبقًا لقرارات ٢٥ مارس.
غير أن صاوي ومحمدي غادرا منزل نجيب إلى هيئة التحرير مباشرة، وقابلا إبراهيم الطحاوي وأحمد طعيمة (مسئول العمال في الهيئة)، وأبلغاهما بمضمون لقائهما مع نجيب، وتم الاتفاق على القيام بالإضراب مقابل مبلغ من المال أيضًا مع تحويل الهتاف المتفق عليه مع نجيب إلى المطالبة ببقاء مجلس الثورة وليس عودة الضباط إلى الثكنات. وقد كان.
وفي نفس يوم الإضراب اجتمع ضباط الجيش من جميع الأسلحة في ثكناتهم للتداول في الموقف، وانتهوا إلى أن الثورة مهددة إذا نُفذت قرارات مارس، فقرروا الاعتصام. وفي يوم ٢٩ مارس، وبعد ثلاثة أيام من الإضراب، تقرر إرجاء تنفيذ قرارات مارس حتى نهاية فترة الانتقال المقررة سلفًا (يناير ١٩٥٦)، وتشكيل مجلس وطني يراعى فيه التمثيل النسبي لفئات الشعب وطوائفه، وانتهى الإضراب يوم 30 مارس.
حسم الصراع
وخرج عبد الناصر من الأزمة منتصرًا، إذ عاد رئيسًا للوزراء وأخذ يتابع الأمور حتى تستقر نهائيًا في يده، ولا تقوم لعناصر الثورة المضادة قومة أخرى. فنراه يقوم باعتقال مجموعة من الضباط بقيادة أحمد المصري كانت تسمى "الإحداث"، فتنة داخل الجيش. ويقدّم المسئولين عن الفساد السياسي في العهد الملكي للمحاكمة (٥ أبريل)، ويقرر حرمان الوزراء الذين تولوا قبل ١٩٥٢ من مباشرة الحقوق السياسية، ويحل مجلس نقابة الصحفيين (٥ أبريل).
وفي سبتمبر ١٩٥٤ يُحاكم اليوزباشي مصطفى كمال، رجل الحرس الحديدي الملكي السابق، في مؤامرة لقلب نظام الحكم. ثم يُطلق الرصاص على جمال عبد الناصر في ميدان المنشية (٢١ أكتوبر)، فتكون فرصته للتخلص من الإخوان المسلمين وتنتهي مرحلة توظيفهم بين المتصارعين.
وكانت هذه الإجراءات كفيلة بتجميد نشاط محمد نجيب، إذ أصبح وحيدًا دون معاونين. وبعد توقيع اتفاقية الجلاء (١٩ أكتوبر) لم يعد هناك ما يدعو للإبقاء على محمد نجيب، فتقرر إعفاؤه من جميع مناصبه في ١٤ نوفمبر ١٩٥٤، وتحديد إقامته، وخلصت الثورة لأصحابها الحقيقيين بعد شهور من المرارة والعنت.
وبعد كل هذا.. هل كان على ثوار يوليو أن يعودوا إلى الثكنات العسكرية وأن يضعوا رقابهم في حبل المشنقة بعد أن نجحوا فيما عجزت عن تحقيقه كافة القوى السياسية في مصر منذ ثورة عرابي ١٨٨١؟
وهل أخطأ عبد الناصر عندما فكر في تقديم رتبة عسكرية كبيرة واجهةً للضباط الأحرار (محمد نجيب) لتصبح مصيدة تلتف حولها القوى السياسية القديمة لضرب الثورة التي صنعته هو؟!!
وهل لخطة عبد الناصر في مغازلة الشارع الإسلامي باستثناء الإخوان المسلمين من قرار حل الأحزاب، فشعروا بتميزهم وبدأوا في فرض شروطهم لتأييد الحكم، أثر في تأجيج الأزمة؟
وما هي الثورة التي قامت في أي بلد في العالم وقبلت في شهورها الأولى المشاركة السياسية من عناصر قامت ضدها، حتى تقيم هذه العناصر – ومن لفّ لفّهم – في مارس من كل عام مأتمًا لموت الديمقراطية!!